هذا المقال جزء من سلسلة خاصة من المقالات بقلم المدونة والناشطة مرسيل شحوارو، واصفة حقيقة الحياة في سوريا تحت نير الصدام المسلح بين القوات النظامية وكتائب الجيش الحر.
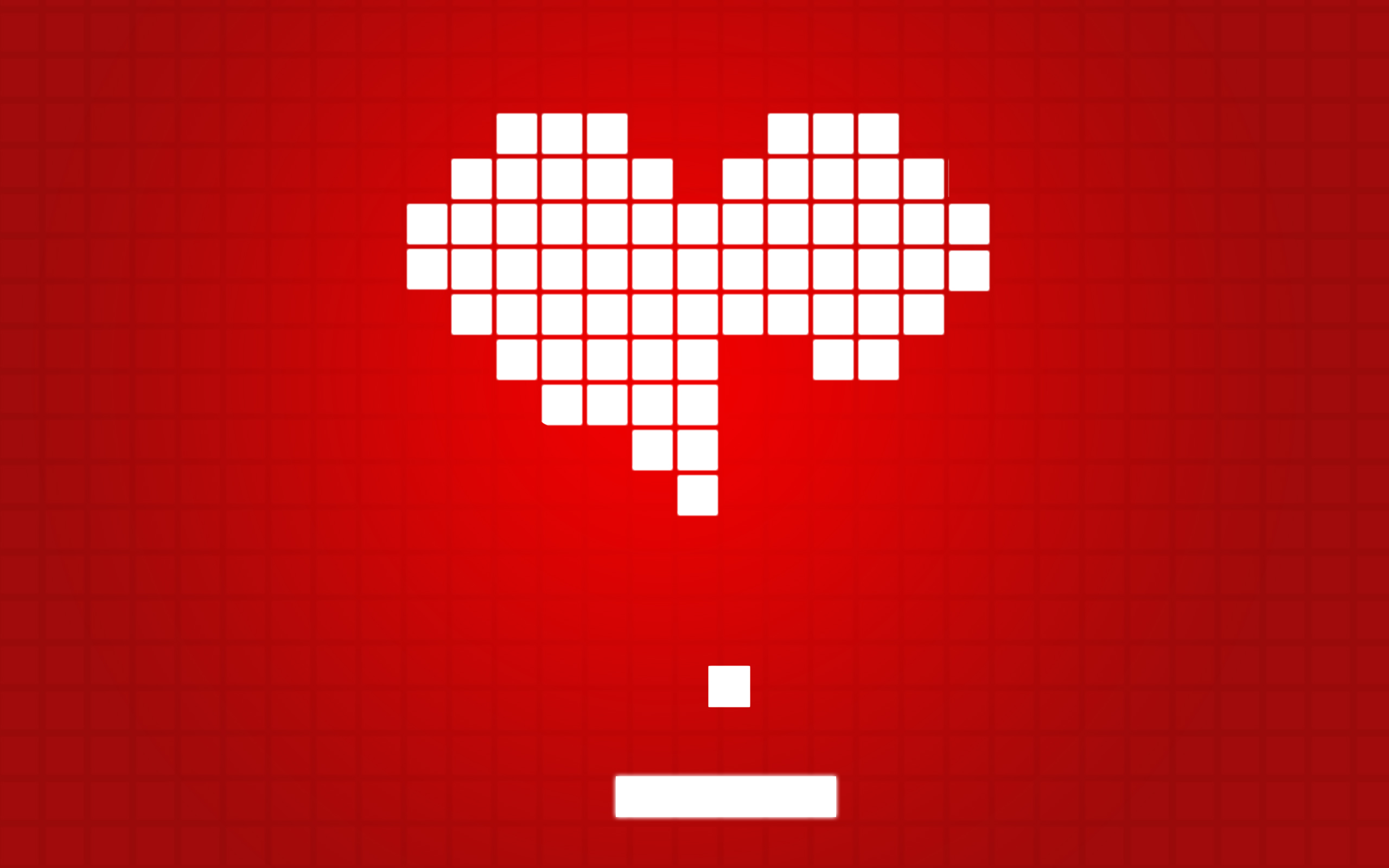
لعب القلوب – تصميم ZedLord-Art على ديفيانت آرت. مستخدمة برخصة المشاع الإبداعي النسخة الثالثة
قالوا لي من اليوم الأول أن زوجها بالمعتقل، وأن الأغاني التي أغنيها دومًا في كل مكان قد تكون سببًا في إثارة الشجن. لم أهتز حزنًا للخبر، كم اعتدنا على قصص عائلات المعتقلين وكأن الطبيعي أن نسجن في سوريا الأسد ومن هم خارج السجن أو يظنون أنفسهم كذلك هم الاستثناء. وعلى العشاء، على انفراد سألتها وكمقدمة للتعارف ربما لا أكثر: كيف اعتقل زوجك؟ وتجيب بغصة مملوءة بالحب: بعدما تمكنت من إيصال خبر اعتقالي على حاجز للفرقة الرابعة في الجيش على الطريق من داريا إلى دمشق، قاد “المجنون” السيارة إلى الحاجز ليسأل عني فاعتقلوه. وتتنهد لتتابع: لا تظني أنه فعل ذلك بدافع الذكورية فحسب، زوجي يحبني كثيرًا لقد تزوجنا عن حب.
وتلمع عيناها بالحياء المحافظ الحزين
وأتساءل مرغمة عن قوة ذاك الحب الذي تقود المحبوب إلى حواجز الفرقة الرابعة التي يتزعمها ماهر الأسد والمشهورة بشراستها وقسوتها. وأحاول أن أخفي تأثري العاطفي الرومانسي وأنا أسألها: هل رأيته بعدها؟ فتجيب بابتسامة متفهمة لفضولي المراهق: لم أكن أدري انه اعتقل حتى رأيته بعد شهر من اعتقالي، كانوا يقومون بنقلنا إلى مكان آخر بالسيارة ذاتها وكان يبدو عليه آثار التعذيب بشدة، وعلى الرغم من أن الحارس نهره ومنعه من الحديث معي لكنه بشجاعة سألني: هل أنت بخير؟ وبالكاد استطعت أن أهز رأسي وأقول الحمد لله قبل أن يصرخ الحارس بنا مجددًا ومن يومها منذ ما يقارب التسع شهور لم أره أو أسمع عنه ولا أدري حتى أين هو.
وحين اعتقدت أن شجاعة حبهما تقف عند هذا الحد، تفاجئني هي بقولها: بعد سبعة شهور من بقائي في السجن والعذاب الذي عانيته لم أكن أفكر إلا به وبأولادي، وحالما خرجت ودون أن أستشير أحدًا من أهلي او حتى أن ألتقي بأولادي، ذهبت سرًا إلى باب فرع الأمن الجوي في دمشق.
ولم أتمالك نفسي من أن أصرخ بها بغضب فخور: الجوية؟ الفرع الأقسى؟ كيف تفعلين ذلك؟ أجننت؟
وتدمع عيناها: لقد سمعت أن زوجي قد يكون هناك وكان عليّ أن أذهب لأسأل عنه، طالبت به وسألتهم عنه وصرخت لكنهم هددوا باعتقالي ففكرت بأولادي واضطررت إلى العودة إلى المنزل وعندما سمع أهلي بما فعلت، خافوا عليّ كثيرًا وضغطوا علي أن أنتقل مع أولادي إلى لبنان.
تتنهد وتتابع: لكنني لم استطع أن أسكن بيروت، إنها بعيدة جدًا عن دمشق أسكن قرب الحدود وعيناي تناظر العودة. ادعي له يا مرسيل، ادعي له أن يكون لازال حيًا وأن يخرج سالمًا.
ومازحتها: هل نحن مدعوون إلى وليمة حينها؟ لتجيب بأمل مؤمن: طبعًا.
أينما بحثت في تفاصيل العنف والموت والدم في سوريا، تصادفك قصة حب مجنونة وشجاعة كزهرة تنمو عصية على الأشواك أن تخنقها. قصص حب على طرف المعبر وعلى الرغم من أنف القناص الذي يقسم المدينة قسمين، حب بين المدينة ومخيمات اللجوء أو المدن على الحدود التركية، مسلحون من الجيش الحر وحبيبات لا يستطيعون أن يزرنهن مالم يسقط النظام. هذا ما يعنيه أن تحيا دومًا على الحافة، تلامس الموت وتسخر منه بتمسكك بالحياة لتضفي عليها بعض المعنى بالبحث عن ابتسامة من تحب.
تلحظ صديقتي البطلة شرودي الساهي بالقلادة التي أهداني إياها من أحب فتقطع سلسلة الأفكار بسؤال مباشر: ما قصته؟ وأجيب بصراحة وصدق: أعتقد أنه يستحق من هي أفضل، أو على الأقل يستحق فتاةً لا يحلم ليلًا أن الموت قد خطفها ولا يطاردها من قلق إلى آخر، يستحق فتاة لديها من ثبات الغد ما تستطيع أن تبني عليه عائلة.
فتضحك مني ومن سذاجة عاطفتي لتقول: هل تعتقدين أن زوجي كان سيحبني أكثر لو كنت أقل ثورية ً مما أنا؟ وأخجل من الإجابة التي لست أدريها تمامًا.
بالحب وحده ، تلك العاطفة التي تلحمنا مع أرضنا ومستقبلنا وحريتنا والحياة التي تصبح أصعب وأصعب إن هي أمتلأت بالحقد والكراهية فقط.
بهذا الحب لسوريا وللغد، سنسقط كل طغيان العنف وننتصر.








1 تعليق